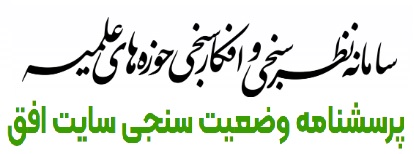الندوة العلمية
دور العلوم التجريبية في عملية الاستنباط
الآفاق- بحسب تقرير العلاقات العامة لمؤسسة دانشوَران البحثية، عُقدت ندوة علمية بعنوان «اعتبار أبحاث العلوم التجريبية في الفقه» بحضور الأستاذ الشيخ حميد درايتي في المدرسة العليا للفقاهة لآل محمد (ع) وذلك يوم الخميس 18 شوال المکرم 1446 هـ. وفيما يلي نص هذه الجلسة يُعرض أمام القرّاء:
علاقة العلوم التجريبية بالعلوم الإنسانية
الموضوع الذي يُناقَش في هذه الجلسة هو دور العلوم التجريبية في عملية الاستنباط. أول نقطة يجب الانتباه إليها في بداية البحث هي أن إطلاق عنوان العلوم التجريبية على العلوم الإنسانية محل خلاف بين الآراء؛ فالبعض يعتبر العلوم الإنسانية جزءاً من العلوم التجريبية، فيما لا يعتقد آخرون بذلك. شخصياً أرى أن العلوم التجريبية تختلف عن العلوم الإنسانية؛ ولكن يمكن، بنظرة أكثر شمولية، إدراج العلوم الإنسانية أيضاً تحت مظلة العلوم التجريبية. كذلك يمكن إدخال علوم غير تجريبية كالإحصاء والرياضيات في هذا النقاش، فلا ينحصر موضوع البحث في العلوم التجريبية فقط. حالياً سنركز نقاشنا على غير العلوم الإنسانية، وإذا دعت الحاجة سننتقل إلى مجالات أخرى.
دور العلوم التجريبية في فهم الدين بشكل عام
النقطة الثانية هي أنه يُثار أحياناً سؤال حول دور العلوم التجريبية في فهم الدين بشكل عام أو مصادره؟ في هذا المجال هناك آراء متعددة؛ فبعضهم يرى أن التفسير العلمي للقرآن والاستفادة من النتائج التجريبية يمكن أن يساعد في الفهم الأفضل للآيات القرآنية؛ فآيات كانت تُفسر سابقاً ببساطة، باتت اليوم، بمساعدة العلوم التجريبية، تُفهم بشكل أعمق، مثل الآية: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ» (فصلت/11) التي كانت تُفَسَّر في السابق بأنها تعني الدخان، أما اليوم وبفضل الاكتشافات العلمية تُفسَّر بأنها تعني الغاز. أو الآية: «أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَیْءٍ حَيٍّ» (الأنبياء/30)؛ حيث يُشار إلى ظاهرة الانفجار العظيم (Big Bang). كذلك الآيات التي تشير إلى الذرة وما هو أصغر منها، أصبحت تحمل معانٍ أعمق بفضل الاكتشافات العلمية الحديثة. في القرآن الكريم، هناك مواضيع كتلقيح السحب، والنباتات، وغيرها من المسائل العلمية التي يمكن بالعلوم التجريبية فهم نقاط جديدة وعميقة فيها. ومع ذلك، فإن محور بحثنا في هذه الجلسة يقتصر على الاستنباط الفقهي لنتمكن من تناول الموضوع بدقة أكبر.
دور العلوم التجريبية في الاستنباط الفقهي
محور بحثنا الرئيسي هو دور العلوم التجريبية في الاستنباط الفقهي. كمقدمة يجب تحديد نقاط تماس المعرفة التجريبية مع الاستنباط الفقهي، وفحص ما إذا كانت هذه النقاط موضع اعتبار أم لا.
العلوم التجريبية وتحديد مصادر النصوص الدينية
أول مسألة تُطرح هي: هل يمكن للعلوم التجريبية مساعدتنا في تحديد مصادر النصوص الدينية؟ بعض فروع المعرفة التجريبية قد تساهم في إحراز أصالة الوثائق. على سبيل المثال، بالنسبة للقرآن الكريم، يمكن بالإضافة إلى التواتر، استخدام الأساليب العلمية لتحديد عمر المخطوطات القرآنية. هذه الأساليب قد تُستخدم كأداة للتحقق من أصالة الوثائق، وإن كان مدى اعتبارها نفسه محل نقاش.
فيما يخص النصوص المكتوبة، يمكن للمعرفة التجريبية أن تلعب دوراً في تحديد أصالة الوثيقة، وهو دور مهم جداً. ومن أهم القضايا الحساسة لدينا هي تحديد أصالة الوثيقة؛ أما في ما يتعلق بالروايات الشفهية، فما زالت الحلول العلمية في هذا المجال بدائية، وقد تظهر في المستقبل طرق للتحقق من أصالتها.
تفعيل الإحصاء والرياضيات في تفسير الألفاظ الدينية
بعد مرحلة أصالة الوثيقة، يُطرح موضوع الاستظهار (استخراج المعنى). المعرفة التجريبية يمكن أن تساعد في هذا المجال من وجهتين: كأداة، وكمنبع للنتائج العلمية.
أدوات مثل الحاسوب والذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد الباحثين في البحث عن القرائن. كذلك، إذا عممنا المعرفة التجريبية إلى مجالات كالإحصاء والرياضيات، يمكن تقديم نماذج للاستظهار قائمة على البيانات الإحصائية. مثلاً، إذا استنبط ألف فقيه عبر التاريخ معنى معيناً من حديث وقلائل استنبطوا معنى آخر، يمكن الاستفادة من هذه البيانات لتقوية الظهور النوعي للحديث.
دور الأدوات العلمية والإحصائية في تحليل الأدلة الفقهية من حيث الكمّ والكثرة
في المواضيع المعتمدة على الكمّ والكثرة، يجب أن توجد أدوات وطرق لقياس وجمع البيانات حتى يمكن فحص الادعاءات المستندة إلى الإجماع، الشهرة، السيرة، والتواتر بدقة. في الماضي كان البحث مقتصراً على مصادر محدودة، أما اليوم ومع تطور الأدوات العلمية والإحصائية، يمكن دراسة البيانات وتحليلها على نطاق أوسع.
دور العلوم التجريبية في مجال المفهوم
نقطة التماس التالية في مجال المفاهيم. بعض القضايا الفقهية مثل الموت، الجنون، والمرض كان لها تعريفات عرفية بسيطة، لكن المعرفة التجريبية قدّمت تعريفات أدق وأنواعاً متعددة لها؛ فمثلاً في الفقه لدينا موضوع "الجنون". الجنون هو موضوع واحد، بينما في الطب النفسي له تعريف محدد، بل وأنواع متعددة. في الماضي كان للجنون تعريف عرفي بسيط، وكانت الاستنباطات محدودة، أما اليوم فقد أصبح تعريفها أدق وأعمق، وتعددت أنواعها. اليوم إذا ذكرت الجنون تُسأل: أي نوع تقصد تحديداً؟ بينما في السابق كان يشار فقط إلى الجنون الدوري، أما اليوم فقد عُرفت له أنواع متعددة.
في الحقيقة، العلم الحديث أعاد تعريف بعض موضوعاتنا الفقهية وحدد أنواعها. فتُسأل: "أي من هذه الأنواع تقصد؟" وهذه نقطة مهمة جداً بين العلوم الحديثة والفقه. هذه نقطة تماس واضحة، فلدينا العديد من الموضوعات التي للعلوم الحديثة تعريفات خاصة لها؛ مثلاً في الدين جاء: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، أي من كان منكم مريضاً أو على سفر فلا يصم وليقضه لاحقاً. لكن ما هو المرض؟ كان تعريفه سابقاً بسيطاً وعرفياً، واليوم للعلم أنواع من المرض ربما لم نكن نعرفها سابقاً كأمراض، أما اليوم نعرف أنها أمراض وتحتاج علاجاً.
كذلك، المعرفة التجريبية أحياناً تكتشف موضوعات جديدة لم تكن معروفة سابقاً؛ مثل أهمية البيئة ودور الأشجار فيها، وهو أمر كشفه العلم الحديث وأدى إلى أن تُصبح قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ذات أبعاد أوسع. وأيضاً، المعرفة التجريبية أحياناً تخلق موضوعات لم يكن لها منفعة محللة سابقاً، مثل الدم الذي لم يكن مباح البيع سابقاً، أما اليوم وبفضل تقدم الطب أصبح الدم ذا منافع محللة ومصدراً مفيداً.
في المجمل، يمكن للعلوم التجريبية عبر أدواتها ونتائجها واكتشافاتها أن تلعب دوراً في عملية الاستنباط الفقهي، خاصة في إحراز أصالة الوثيقة، الاستظهار، ومجال المفهوم، وتوجد نقاط تماس ملحوظة بين المجالين.
أثر المعرفة التجريبية على تغيير موضوعات الفقه
اليوم اكتشف العلم البشري العديد من الموضوعات بل خلقها، وهذا بدوره أدى إلى تغيّر بعض الأحكام الفقهية تبعاً لتغيّر الموضوعات. فمثلاً في الفقه التقليدي، لم يكن يجوز بيع وشراء عضو مقطوع من الإنسان، أما اليوم ومع تقدم الطب وإمكانية زراعة الأعضاء، أعيد النظر في هذا الموضوع واعتبر بيع وشراء الأعضاء بغرض الزراعة جائزاً. وفي كثير من الحالات لم يقتصر دور المعرفة التجريبية على تعريف خصائص جديدة للموضوعات السابقة، بل طرحت موضوعات جديدة مثل التعديل الوراثي، التغيير الجيني، التلقيح الصناعي، الرحم المستأجر والاستنساخ، وهي موضوعات لم يكن لها سابقة في الفقه.
هذه التحولات أدت إلى نتائج مهمة. مثلاً بعض الموضوعات التي لم يكن لها أي منفعة سابقاً أصبحت ذات منفعة فغُيّر حكمها الفقهي؛ فالدم كان يُعتبر بلا منفعة ولا يجوز بيعه، أما اليوم مع إمكان نقل الدم وإنقاذ الأرواح، أصبح بيعه جائزاً. أيضاً بعض الموضوعات الجديدة جعلت الفقه التقليدي يفتقر إلى حكم محدد لها، بل وتغيرت بعض المعادلات الفقهية التقليدية، مثل قضايا الرحم المستأجر وتحديد النسب والإرث التي خلقت تحديات جديدة للفقه.
هناك من يعتقد أن المعرفة التجريبية يمكنها أن تعرف وتكشف موضوعات جديدة، وتوجد آثاراً جديدة للموضوعات السابقة، ولذا فهي مؤثرة في الاستنباط الفقهي؛ أحياناً يكون هذا التأثير واضحاً في تغيير الحكم، وأحياناً يثير جدلاً وتحديات فقهية. كذلك يمكن للمعرفة التجريبية أن تقدم طرقاً موازية للطرق الفقهية التقليدية؛ فمثلاً في إثبات النسب يعتمد الفقه على قاعدة الفراش، بينما المعرفة التجريبية تثبت النسب بتحليل الحمض النووي (DNA). أو في تحديد القبلة وأوقات الصلاة، أصبحت الأدوات العلمية الدقيقة بديلاً عن العلامات التقليدية. هذه أمثلة على نقاط التماس بين المعرفة التجريبية والبحث الفقهي سواء في الموضوعات ومتعلقات الأحكام أو أحياناً حتى في الحكم نفسه.
التمييز بين التعاريف العرفية والتعاريف التخصصية الحديثة في الأحكام الفقهية
فيما يخص تعريف المفاهيم، التحدي الأساسي في الفقه التقليدي هو أن كثيراً من المفاهيم عُرّفت وفق العرف السائد في زمن صدور الحكم، والتعاريف العلمية الحديثة لا تُعتبر أساساً للحكم الشرعي إلا إذا تمكنت المعرفة التجريبية من تحديد العرف التاريخي زمن صدور الحكم. وإلا فإن الفقه التقليدي لا يقبل التعريفات العلمية الحديثة.
مثال ذلك، مفهوم "المريض" أو "المجنون" في الفقه يُحدد حسب الفهم العرفي لأهل ذلك الزمان، لا وفقاً للتعاريف العلمية الحديثة.
وفي النهاية يجب التفريق بين الحالات التي يمكن للمعرفة التجريبية أن يكون لها دور في تعريف الموضوع وتحديد الحكم، والحالات التي يعتمد فيها الفقه فقط على العرف والفهم العام. كما يجب الانتباه إلى أن المصالح والمفاسد التي ينظر إليها الفقه تشمل المادية والمعنوية والروحية، بينما المعرفة التجريبية تهتم غالباً بالمصالح والمفاسد المادية والنفسية. ولهذا، فإن تماس العلوم التجريبية مع الفقه يقتصر على الحالات التي لم يصدر فيها الشارع المقدس حكماً خاصاً أو طرأت موضوعات جديدة تحتاج إلى مراجعة فقهية.
ومع ذلك، ففي بعض الحالات يأخذ الفقه برأي المختصين والأدوات العلمية، مثل تشخيص المرض للترخيص في الفطر في الصيام حيث يُعتبر رأي الطبيب والأدوات المخبرية معتبراً. هذه الفروق والفواصل يجب تحليلها بدقة لمعرفة متى تكون التعاريف والأدوات العلمية معتبرة ومتى لا تكون كذلك.
أهمية المصالح المعنوية في تحديد نطاق العلاقة بين العلوم التجريبية والفقه
وفي النهاية يجب الانتباه إلى أن المصالح والمفاسد التي يراعيها الفقه تشمل المادية والمعنوية والروحية، أما المعرفة التجريبية فتركز غالباً على المادية والنفسية. لذا فإن تماس العلوم التجريبية مع الفقه يقتصر على الحالات التي لم يصدر فيها الشارع المقدس حكماً خاصاً أو طرأت موضوعات جديدة تحتاج إلى اجتهاد فقهي جديد. وفي بعض المجالات مثل "منطقة الفراغ"، إذا لم يصدر الشارع حكماً خاصاً، قد توكل التشريعات للإنسان نفسه، ولكن هذه القوانين لا تكتسب بالضرورة طابع الشرعية ولا تترتب عليها آثار الطاعة أو المعصية الشرعية.
بالخلاصة، يمكن للمعرفة التجريبية أن تساعد الفقه في بعض المجالات، لكن في كثير من الحالات، يظل الفقه التقليدي يستند إلى العرف والفهم العام زمن صدور الحكم، ولا يعتمد التعاريف العلمية الحديثة إلا إذا أمكن معرفة العرف التاريخي أو أحال الشارع صراحة إلى رأي المختصين.
المصدر: موقع: derayati.com
برچسب ها :
ارسال دیدگاه