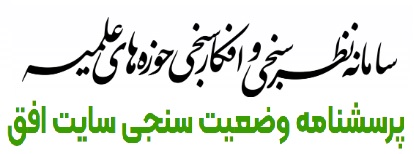الملخّص
بعد ذكره لأهمية البحث وخطورته تعرض الكاتب -حول التعدديّة الدينيّة- لمعناها، وذكر أنَّ هناك خلطاً أساسياً يتعلق بعدم التفريق بين الدين والشريعة، وأنّ الدين لا يتعدد بعكس الشريعة، وتعرض لثلاث نظريات للتعددية الدينيّة ذاكراً أهم النقوضات عليها، مستنتجاً قبول واحدة منها فقط.
الجزء الأول
أهميّة البحث
إنَّ التَّعدُّدية في ذات الدِّين أو في فهم الدِّين مقولةٌ يراد من خلالها تمييع العقائد والأحکام والأخلاق للدِّين الإسلامي الحقِّ، وإضعاف الارتباط الرَّاسخ به کدينٍ يمتلك منظومة متکاملة على المستوی العقدي والقيمي والعلمي، قادرة علی تلبية حاجات الفرد والمجتمع من المهد إلى اللَّحد.
فالدِّين الإسلامي بقرآنه {لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} (فصلت:٤٢) المنزّل على نبيّه -خاتم الأنبياء-(ص) الأکمل الذي لا ينطق عن الهوی، وشريعته السَّماوية السمحاء، هو الدِّين الخاتم الذي تکفَّلت عناية الله عزوجل بحفظه فحريٌ أن يتبَّع ليصنع الإنسانَ في کلِّ أبعاده، ويتسامی به نحو الهدف الذي خلق من أجلِه، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران/85).
من هنا تکمن أهمية التعرُّف علی هذه الأطروحات حتی يترسَّخ ويتأصَّل الارتباطُ بالدِّين الإسلاميّ الحقِّ في العُقول والقُلوب فينعکس علی السُلوك، وأيضاً حتی ترتفع هذه الشُّبهات عن بعض العقول المتزلزلة والقلوب المترددة. نسأل الله سبحانه وتعالی التوفيق لذلك.
تعريف التَّعدُّدية
تعني التَّعدُّدية (Pluralism) لغويّاً الکثرة والتَّنوع، وقد أُطلقت لأوَّل مرَّةٍ في الکنيسة علی من کانوا يشغلون مناصب عديدة.
أوَّل من أدخل مصطلح "البلورالية" في حقل الفلسفة هو "لوتسه - Lhotse" في کتابه "ما بعد الطبيعة" وذلك عام 1841م.
المسار التاريخي للتعددية الدِّينية
التَّعدُّدية الدِّينية (Religious Pluralism) من المسائل الكلامية حديثة الظُّهور، وقد جرت مؤخَّراً على الألسن وصدرت حولها كُتب ومقالات مختلفة في بيانها ونقدها.
يتكوَّن عنوان "البيلوراليزم الدِّينيّ" من کلمتين "بيلوراليزم" و"دينيّ" والمراد به "کثرة الأديان وتعددها"؛ فالمقصود من "التَّعدُّدية الدِّينيّة" ما يقابل الوحدانيّة والتَّفرد، أو ما يصطلح عليه "الانحصاريّة في الدِّين" في مقابل "الشُّموليّة".
وعلينا أن نحدِّد أوّلاً مکان ولادة التَّعدُّديّة، وهل المتکلِّمون الغربيون هم أوَّل من أثاروا الموضوع ثمَّ دخل دائرة علم الكلام، أو أنَّ للمسألة جذوراً في الفلسفة الإسلامية والكلام الإسلامي أيضاً، أو کلاهما أثار المسألة دون أن يقتبس أحدهما من الآخر.
وقد نُسب أصلُ الموضوع إلى عدِّة أسماء:
يوحنَّا الدِّمشقيّ: وأنَّه هو مبتکر هذه المسئلة، وقد کتب فيها رسالة.
ويوحنَّا الدِّمشقيّ کان من المسيحيين المقربين للخُلفاء العبَّاسيّين کالمأمون والمعتصم والواثق والمتوکل (مستشار ثقافيّ)، وقد استرعت اهتمامَ الخلفاء به معلوماتُه الباهرة في الطَّب، وهو الذَّي أثار فتنة "قدم القرآن"، و"عدم حدوث کلام الله"، لکي يثبت بـ"قدم کلام الله" قدم المسيح "کلمة الله"، وقد توفي يوحنَّا الدمشقيّ في سامراء عام 248هـ.
ولما کانت رسالته مفقودة فلا يمکن محاکمتها، ومع فرض صحَّة نسبتها له، فربما کان يهدف منها "التَّعايش بين المسلمين والمسيحيّين" في ظلِّ الدَّولة العباسية، ومن الممکن أن يکون هدفه مشابهاً لهدفه في مسألة "خلق القرآن" إذ أراد من خلال قوله: "إنَّ اتِّباع جميع الأديان موجب السعادة" أن يخفِّف من حدَّة تعصُّب المسلمين، وأن يجعل أتباع الأديان الأخری في مستوى المسلمين. هکذا قيل، وکلُّه مجرد حدس.
إخوان الصفا وخلان الوفا: وهم جماعة من فلاسفة المسلمين من أهل القرن الثَّالث الهجريّ والعاشر الميلاديّ بالبصرة، اتَّحدوا على أن يوفِّقوا بين العقائد الإسلاميّة والحقائق الفلسفيّة المعروفة في ذلك العهد، فکتبوا في ذلك خمسين مقالة سموها "تحف إخوان الصفا".
وقد تعرَّض إخوانُ الصَّفا في رسائلهم إلى مسألة التَّعدُّديّة الدِّينيّة، إذ قالوا: "الحقُّ موجودٌ في کلِّ دين، والحقُّ يجري على کلِّ إنسان، ومن الممکن تعرض الشبهة على کلِّ إنسان.. إذا احتملتَ وجود دين أفضل ممَّا أنت عليه فلا تقتنع، والأفضل لك أن تبحث، فمتی وجدتَه فلا تصرُّ علی الدِّين المفضول، وعليك أن تدين بالدِّين الأفضل وتحبَّه".
إنَّ العبارة الأساسية التي تفيد وجود نوع من الحقِّ لجميع الأديان هي قولهم: "ليس الحقُّ منحصراً بدين واحد من بين جميع الأديان، وليست الأديان الأخری لا تمتلك نصيباً من الحقِّ، وإنَّما هناك قيد مشترك بين جميع الأديان السَّماوية".
وهذا الكلام ليس جديداً وإنَّما نادی به الإسلام؛ إذ دعا القرآن الکريم أهلَ الکتاب إلى القدر المشترك، وهو "التوحيد في العبادة": {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (آلعمران/64).
ثمَّ إنَّ کلامَهم السابق يفرض على کلِّ إنسان اتَّباع القانون الأفضل، والسَّعي للتعرُّف عليه، وهذا الكلام يؤکِّد أنَّ هؤلاء من دعاة الانحصارية في الدِّين، وليس التَّعدُّدية الدِّينية.
وقد قيل إنَّ في عام 1950م لم تكن هناك أي إشارة إلى هذه المسألة في السَّاحة الفكرية الإسلامية، ممَّا يؤکد أنَّ "لبيلوراليزم" فکرة غربيّة بشکلٍّ کامل، ثمَّ تسلَّلت إلى الفِکر الشَّرقيّ.
التعددية الدينيّة في إيران
إنَّ أوَّل من تناول التَّعدُّدية الدِّينية في إيران هو الدکتور "ميمندي نجاد" في النَّصف الثَّاني من القرن العشرين، واستدلَّ بالآية الكريمة الآتية على نجاة جميع أتباع الدِّيانات السماوية وهي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة/62)، وبمضمونها في سور أخرى (المائدة 169- الحج 17).
وقد تناول المفسِّرون هذه الآيات وأشاروا تصريحاً أو تلميحاً أنَّ هذا الفهمَ خاطئ، وقد اعتبره أبو الأعلى المودودي کما في کتاب "الإسلام في مواجهة التَّحديات المعاصرة" بأنَّه أکبر افتراءٍ على القرآن الکريم.
ويمکن مراجعة جواب هذه الشُّبهة بشکلٍ تفصيلي في کتاب "مفاهيم القرآن" للشيخ السبحانيّ.
وهناك کتابان سادا الوسط الفکريّ، وهما:
1. فلسفة الدِّين لـ"جون هيك" وهو مسيحيّ من مواليد 1922م، فيلسوف وأستاذ في فلسفة الدِّين والتَّعدُّدية الدِّينيّة، وهو من انجلترا، تُوفي عام 2012م.
وقد طرح في کتابه مسألة التَّعدُّديّة الدِّينيّة کفهم جديد للکتب السَّماويّة ودافع عنها بقوَّة.
2. صراطهاي مستقيم (السُرط-جمع صراط-المستقيمة) تأليف عبد الکريم سروش، الذَّي تبنَّي رأي جون هيك وأعاد صياغة أفکاره.
وهذا الکتاب لو تجاوزنا محتواه، فإنَّ عنوانه يتعارض مع القرآن الکريم الذي حصر النَّجاة والسعادة بطريق واحد، يقول تعالى: {وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام/153).
عبدالکريم سروش -هو الاسم المستعار لحسين حاجي فرج دبّاغ- من کبار المثقَّفين الإيرانيين المعاصرين من مواليد طهران سنة 1945م، حصل على الدکتوراه في فرع الکيمياء في جامعة لندن، تأثَّر بـ"جون هيك"، وکان من الأفضل للمؤلف أن لا يسمي کتابَه بهذا الاسم لکي لا يقع في تعارض صريح مع القرآن الکريم.
هذانِ الکتابان، -إضافة إلى الکتب الكلاميّة المترجمة-، وصيرورة الثَّقافة ثقافة إعلاميّة، کلُّ ذلك کان وراء انتشار هذه القضية، وکان السَّبب أيضاً وراء کتابِه "رسائل ومقالات مختلفة" حول الموضوع نفسه.
ويندرج تحت هذا العنوان بحثان رئيسيّان هما:
1. التَّعدُّديّة في فهم الدِّين.
2. التَّعدُّديّة في ذات الدِّين.
والمقصود من التَّعدُّدية في فهم الدِّين، هو الاعتقاد بالاستنتاجات والانطباعات المختلفة عن الدِّين، وبالتعبير المتداول اليوم، "القراءات المتعدّدة للدين"، "الهرمونوطيقيا" نظرية تعدد القراءات.
والمقصود من التَّعدُّديّة في ذات الدِّين، هو أنَّ الأديان نفسها تمثل طرقاً مختلفة تفضي إلى الحقيقة الواحدة، أي أنّها في مقام السعادة والصدق والحقّانيّة تقوم بقيادة أتباعها وهدايتهم إلى أمر واحد.
الحديث في المقام عن التَّعدُّدية في ذات الدِّين، ومرجع التَّعدُّدية في الدِّين إنما هو تلك الرؤية التي تحاول أن تبين التعدد الموجود في الديانات، فهذه الأديان التي ظهرت في الماضي والحاضر ما هي نسبتها إلى بعضها البعض؟
وما هي نسبتها إلى الواقع والحقيقة؟
وما هي علاقتها بأتباعها؟
وهذا ما سوف نتناوله ضمن هذا البحث بإذن الله تعالی.
الدِّين والشَّريعة:
من المصطلحات التي ينبغي تحديد معانيها أوّلاً "الدِّين" و"الشَّريعة" وما لم يتَّضح مفهومهما الواقعيّ لا نستطيع أن نقرِّر شيئا بشأن "وحدانيّة الدِّين" أو تعدده.
فمن تحدَّث عن "التَّعدُّديّة الدِّينيّة" لم يفرِّق بين الشَّريعة والدِّين، ولم يوضِّح بأيهما يختص الحديث حول الوحدة والکثرة.
لقد اعتبر القرآن الکريم -وهو أوثق وثيقة لتفسير هذين المصطلحين، وهو الکتاب السماويّ الوحيد الذي لم تنله أيدي التحريف في ألفاظه- اعتبر الدِّين واحداً والشَّريعة متعدِّدة، وأکَّد القرآن الکريم أنَّ جوهر الدِّين واحد في جميع العصور، وقد أمر جميع الأنبياء بتبليغه، ولم يُحدِث الأنبياءُ واحداً بعد الآخر أيَّ تغيير أو اختلاف فيه، وظلَّ شامخاً وثابتاً ومحکماً علی مدی العصور ولا يطاله النَّسخ، لهذا لم يرد لفظ الدِّين في القرآن الکريم إلا بصيغة المفرد ولم يرد قط بصيغة الجمع.
فالدِّين واحدٌ ولا يقبل الکثرة، وحقيقته "التَّسليم لله تعالى" صاحب السلطة والحاکمية والخلق والربوبية، وکلُّ أمَّة قد دعيت لهذه الحقيقة، کلٌّ حسب قدرتها واستعدادها.
ويمکننا أن نؤکِّد ذلك من خلال الإمعان في الآيات القرآنية: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه} (سورة يوسف/40).
ووصفت بعض الآيات التوحيد بالدِّين القيم {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}(التوبة:35، يوسف:40، الروم:30)، فإذا کان التسليم للحق تعالی ونفي التَّسليم لغيره هو الدِّين القيم، إذاً فيجب أن يبقی بالقوة نفسها في جميع العصور {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَٰلِكَ الدِّين الْقَيِّمُ}(سورة الروم/30) ويتلخَّص الدِّين القيم الثابت بالتوحيد في العبادة.
ما هي الشَّريعة؟
"الشَّريعة" و"الشِّرعة" يقال للطريق الموصل إلى الماء، والقرآن الکريم بعد ما يؤکِّد وحدة الدِّين يشير إلى تعدُّد الشَّرائع ووجود الشَّرائع والمناهج.
والمراد بالشرائع:
التعاليم العلميّة والأخلاقيّة التي تنظِّم علاقات الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة، وتحدِّد مسؤوليّة الإنسان أمام الله والنَّاس.
والسَّبب في اختلاف الشرائع هو الاختلاف في الاستعدادات والقدرات والظروف المختلفة الحاکمة في الناس، لهذا نجد الشئ حلالاً في هذه الشَّريعة وحراماً في شريعة أخری.
وعلی هذا تنسخ الشرائع، لکن النَّسخ لا ينال جميع التعاليم العلمية والأخلاقية للشَّريعة، وإنما ينسخ القسم الملازم لتطور الزَّمان والإمکانات واختلاف الظٌّروف.
وقد صرَّح القرآن الکريم باختلاف الشرائع {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة:47).
الدِّين دين الإسلام فقط
حصرت بعض الآيات الدِّين في الإسلام قال تعالى: {إِنَّ الدِّين عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ}(آل عمران/19)، والآية ليست ناظرة إلى عصر الرسول(ص) فقط، بل هي حقيقة مستمرّة في جميع العصور؛ فلذا نرى الأنبياء السابقين يبشِّرون بقدوم النبي محمَّدٍ(ص) قبل ولادته وبعثته.
فإذا کان الدِّين واحد والشرائع متعددة، فيکون معنى الدِّين هو العقائد التوحيديّة والمعارف الإلهيّة التي دُعي جميع الأنبياء إلى تبليغها، وسيکون محورها التَّسليم لله تعالى وعدم عبادة أو إطاعة غيره.
آية أخری تقول: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آلعمران/85).
وهذا الحکم لا يختص أيضاً بعصر الرسول(ص)، وإنّما يسري إلى جميع العصور، فلذا أکَّد القرآن الکريم أنَّ إبراهيم(ع) کان مسلماً {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (آلعمران/67).
تتابع
المصدر: کتابات؛ منصة لأقلام الحوزات العلمیة في البحرین








2222.jpg)