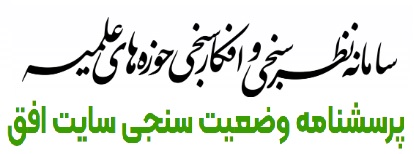مقالة / الجزء الأول
الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي قراءة في جهود التيار النهضوي: الخميني، الطباطبائي، الصدر
الشيخ أحمد المبلّغي
خلاصة المقالة
المقالة تناقش قضية الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي وتبرز أهميتها في قدرة الإسلام على إدارة المجتمعات المعقدة. تستعرض آراء ثلاثة مفكرين إسلاميين: الإمام الخميني، العلامة الطباطبائي، والشهيد الصدر. يقسم العلامة الطباطبائي الأحكام إلى ثابتة ومتغيرة. يركز الإمام الخميني على التحول الموضوعي والولاية المطلقة للفقيه. يطرح الشهيد الصدر نظرية منطقة الفراغ التشريعي، مما يتيح لولي الأمر اتخاذ القرارات وفقًا لاحتياجات الزمن.
أهمية تحليل إشكاليّة الثابت والمتغيّر
يحظى بحث الثابت والمتغيّر في الإسلام بأهميةٍ كبيرة؛ ففي ظلّه نستطيع ان نجلّي قدرة الإسلام على إدارة المجتمعات المعقّدة، ونثبت بطلان الشبهة التي ترى عدم قدرة الأحكام الإسلامية على حلّ مشكلات الإنسانية، أو محدوديّة هذه القدرة مع تزايد احتياجات البشرية وكثرة أزماتها، فهذا الفكر الخاطئ يرى عدم قدرة الأحكام الإسلامية الثابتة على تلبية تلك الاحتياجات المتفاقمة، ورفع الصعوبات المتزايدة وإدارة المجتمعات المعقّدة.
البُعد العلمي في مسألة الثابت والمتغيّر
ليس بحث الثابت والمتغير في الإسلام بحثاً بسيطاً، يمكن إنجازه بتقديم أفكار آنية وموضوعات برّاقة؛ فالبحث في هذا المجال يحتاج ـ من جهة ـ إلى خبرة طويلة بالمجتمعات الإنسانية المعقّدة، كما يتطلّب ـ من جهة أخرى ـ فهم الإسلام وأهدافه وعمق تعاليمه، إضافةً إلى اطّلاع كافٍ على أسس الاجتهاد ومناهجه، وهذه المعارف شرطٌ رئيس في حلّ المعضلة، وحلّ هذه المسألة يحتاج إلى تنظير، أيّ ينبغي على من اكتسب المعرفة حتى أصبحت طوع يده أن يقدّم ـ بشكل جاد وعلى مستوى عال من الدقة مع مراعاة الجوانب كافّة ـ نظريةً تتوافر على خصلتين، هما:
أ ـ تصوير الإسلام وقدراته تصويراً صحيحاً وواضحاً.
ب ـ القدرة على وضع أساس وإطار أفضل للتوجّه الإسلامي والسياسة الإسلامية العامّة.
إن ما قلناه سابقاً دليلٌ على كمال أي نظرية في هذا الخصوص، لكنّ هناك ملاكين إذا تجرّدت النظرية عن أحدهما غدت باطلةً من الأساس، وهما:
أولاً: عدم الخلط بين مساحات الثابت والمتغير، أو الخطأ في تحديد مصاديق كلّ واحدٍ منهما.
ثانياً: أن لا تُبتلى النظرية بتقليد الآراء واجترارها؛ فأغلب من يَرِد هذا البحث لا يملك اطلاعاً على علم أصول الفقه والاجتهاد مما يجعل نظريّته فاقدةً لكلا الملاكين، فلا يضعنّ من ليس له الأهلية قدمه في هذا الوادي السحيق، كما ينبغي على من ينظّر من العلماء أن يراعي الدقة في عمله.
ولكلّ من الإمام الخميني (1989م) والعلامة الطباطبائي (1983م) والشهيد الصدر (1980م) نظرية في هذا الحقل، وهدف هذه الدراسة تقديم خلاصة عن نظريّة كلّ واحدٍ من الثلاثة، مقارنةً بينها، ومن خلال ذلك تتضح كلّ نظرية أكثر، ونقف على أبعاد جديدة للثابت والمتغير في الإسلام، فينفتح لنا طريقٌ لردّ الشبهات الباطلة.
إشكاليّات في مسألة الثابت والمتغيّر
أما أهم تلك الإشكاليّات فهو:
أ ـ الأحكام الإسلامية تحول دون التقدّم والتنمية.
ب ـ افتقار الإسلام إلى الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ج ـ عدم تدخّل الإسلام في الأمور الدنيوية بشكلٍ جادّ؛ لأنّ رسالته الأساسية الاهتمام بالآخرة وما يتعلّق بها.
نظرية العلامة الطباطبائي، الثبات الإنساني والتحوّل البشري
يقول العلامة: قسّم الإسلام أحكامه إلى قسمين متمايزين ومنفصلين بعضهما
عن بعض، الأحكام الثابتة والأحكام المتغيّرة((الطباطبائي، محمد حسين، ملامح من الإسلام (فرازهايي از إسلام): 73، جمع السيد مهدي آيت الهى، طهران، جهان آرا.)).
أمّا الأحكام الثابتة، فهي الأحكام والقوانين التي وضعت على وفق مقتضى حاجات الطبيعة الواحدة والثابتة للإنسان((المصدر نفسه: 69.))؛ فقد سمّى الإسلام تلك الأحكام التي أقامها على أساس طبيعة الإنسان وخصوصيّاته بالدين والشريعة: <فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم>((المصدر نفسه: 69.)).
وأمّا الأحكام المتغيّرة، فهي الأحكام المؤقّتة أو تلك التي لُحظ فيها شيء ما، وتختلف وفق أنماط الحياة المختلفة، ويتماشى هذا القسم مع التقدّم التدريجي للمدنية والحضارة وتغيّر المظاهر الاجتماعية وظهور الأساليب الحديثة وانضمار الأساليب القديمة، وتختلف بحسب مصالح الزمان والمكان المختلفة.
وهذه الأحكام باعتبارها من آثار الولاية العامة، منوطةٌ بنبيّ الإسلام محمد- والقائمين مقامه والمنصوبين من قبله، وتشخّص وتنفّذ في دائرة الثوابت الدينية((المصدر نفسه: 68.))، وطبقاً لمصالح الزمان والمكان، قال تعالى: >يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم< (النساء: 59).
وهناك قسم من هذه الأحكام يعبّر عنه بصلاحيّات الوالي، وقد وضع هذا الأصل في الإسلام ليلبّي حاجات الناس المتغيّرة في كلّ عصر وزمان، وفي كلّ منطقة ومكان، من دون أن تتعرّض أحكام الإسلام الثابتة إلى النسخ والبطلان، كما أنها تغطّي حاجات المجتمعات الإنسانية، وبناءً على الولاية العامة لوليّ أمر المسلمين في دائرة حكومته، وكونه موجّهاً لأفكار المجتمع الإسلامي ومورد قبول الجميع، يمكنه التصرّف في محيطه العام، كما يتصرّف أيّ شخص داخل محيطه الخاص((المصدر نفسه: 76 ـ 77.)).
نظرية الإمام الخميني، التحوّل الموضوعي وإطلاق ولاية الفقيه
يؤكّد الإمام الخميني على أصلين هما:
أ ـ تبدّل موضوع الحكم إلى موضوع آخر في ظلّ العلاقات الحاكمة، يقول بهذا الخصوص: بلحاظ العلاقات الحاكمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد في نظامٍ ما لعلّ حكماً جديداً يطرأ على مسألة ما، كان حكمها السابق يختلف، بمعنى أنّ الإحاطة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جعلت ذلك الموضوع نفسه بالظاهر موضوعاً جديداً فيستتبعه حكم جديد((الخميني، روح الله، صحيفة النور 21: 98، قم، مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني.)).
تكمن أهمية نظرية الإمام الخميني في أنّها ترى ـ من جهة ـ أنّ العصر الحاضر عصر سيادة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقّدة، ومن جهة أخرى تأثير ذلك في تغيير موضوعات الأحكام الشرعية بشكل بسيط وواضح
أهمّ بُعدٍ جديد في نظرية الإمام الخميني أنّ تبدّل الموضوع في ضوئها يمكن أن يتمّ بشكل خفي ودون أيّ ضجيج، أي قد نرى ظاهر الموضوع ساكناً لكنّ هناك تحولاً يجري خلف هذا السكون الظاهري، فقبل هذه النظرية كان الفقهاء يقبلون ذلك حينما يتحوّل الموضوع إلى موضوع آخر، وتبرز علامات تدلّ عليه، كما في استحالة الخمر إلى خلّ أو الميّت إلى ملح، أمّا الإمام الخميني، فإن معرفته بالوقائع المتأثرة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية من جهة، وتعريفه موضوع الحكم الشرعي ومناطه وفلسفته من جهة أخرى، لم يحصرا تبدّل الموضوع بظهور ما يدلّ عليه، مثيراً ـ إلى جانب ذلك ـ فكرة التبدّل الداخلي.
وفي الحقيقة، إنّ ما أحدثه الإمام الخمينيّ من تحوّل في النظرة الأصولية إلى تغيّر الموضوع، حينما طرح فكرة التحول الداخلي له، يضارع ما أحدثه الملا صدرا الشيرازي (1050هـ) في النظرة الفلسفية لموضوع الحركة؛ حينما طرح الحركة الجوهرية، أي أنّ تعيين مصداق الحركة قبل الملا صدرا كان منوطاً بالتحوّلات الظاهرية في الكمّ والكيف، وكذلك كان تعيين مصاديق تبدّل الموضوع قبل الخميني ناظراً إلى التغيّرات الظاهرية.
وعندما نشبّه نظرية الإمام الخميني بنظرية الحركة الجوهرية، فلا ندّعي أنّ جميع الموضوعات عنده تتبدّل بشكلٍ قهريّ في ظلّ العلاقات الاقتصادية والسياسية،
فهذه دعوى لا أساس لها؛ لأن بعض الموضوعات، مثل الموضوعات العبادية وكثير من الموضوعات الأخلاقية، ثابتةٌ على مدى الزمان، فالمقصود من هذا التشبيه أنّ التحوّلات الظاهرية كانت هي المعيار قبل نظرية الإمام الخميني.
ولسنا بصدد إثبات صحّة نظرية السيد الخميني؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى بحثٍ مستقلّ، بل نريد هنا إجراء مقارنة بين هذه النظرية ونظرية العلامة الطباطبائي، وكذا نظرية الشهيد محمد باقر الصدر.
ب ـ الولاية المطلقة للفقيه، يقول الإمام الخميني: الحكومة المتفرّعة عن ولاية رسول الله – المطلقة، هي أحد الأحكام الأوّلية للإسلام، ومقدّمة على جميع الأحكام الفرعية.. فالحكومة قادرة على منع الحجّ، الذي هو من الفرائض الإلهية المهمّة، مؤقتاً، إذا كان في ذلك صلاح البلد الإسلامي((المصدر نفسه 2: 170.)).
نظرية الشهيد الصدر، منطقة الفراغ التشريعي
وخلاصة نظرية الشهيد الصدر:
أ ـ ترك الإسلام، في نظامه التشريعي، منطقةً خالية من أيّ حكمٍ إلزاميّ من وجوب أو حرمة ((الصدر، محمد باقر، اقتصادنا: 721، بيروت، دار التعارف، ط 1980م.))، تسمّى منطقة الفراغ.
ب ـ لا تدلّ منطقة الفراغ على نقصٍ في الصورة التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث((المصدر نفسه: 725.))، بل تعبّر عن استيعاب الصورة، وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة((المصدر نفسه: 722.)).
ج ـ وضع الإسلام منطقة الفراغ الخالية من الحكم تحت تصرّف وليّ الأمر ليملأها على أساس متطلّبات الزمان ومصالحه، وفي ضوء أهداف الشريعة ومقاصدها((المصدر نفسه: 726.)).
تتابع
المصدر: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر
برچسب ها :
ارسال دیدگاه







2222.jpg)